
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا - الآية 155 من سورة النساء
سورة النساء الآية رقم 155 : قراءة و استماع
قراءة و استماع الآية 155 من سورة النساء مكتوبة - عدد الآيات 176 - An-Nisa’ - الصفحة 103 - الجزء 6.
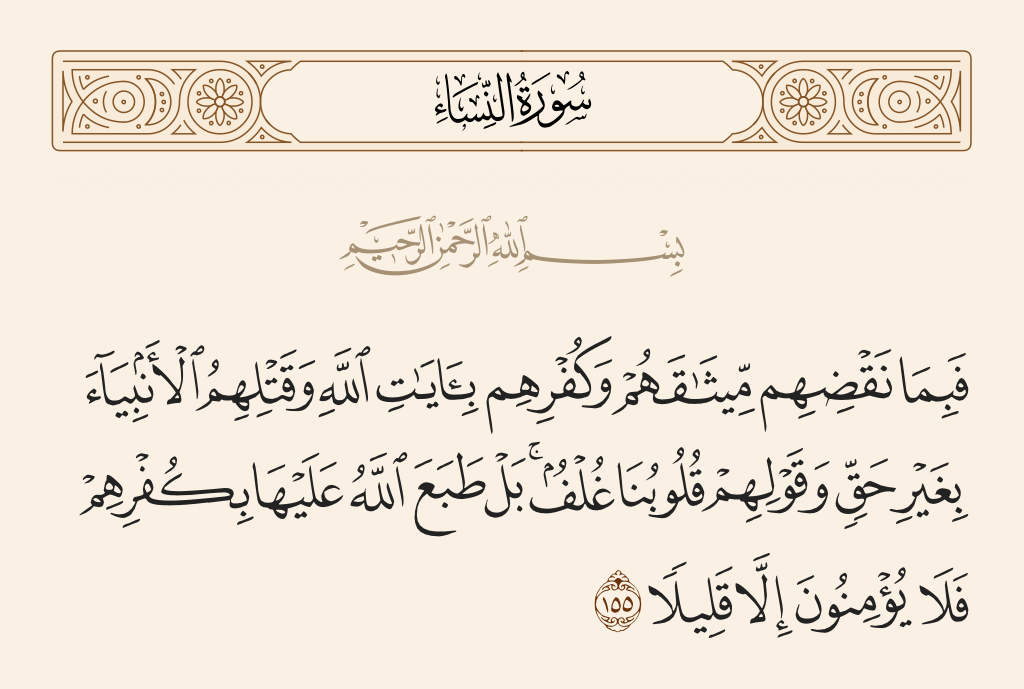
﴿ فَبِمَا نَقۡضِهِم مِّيثَٰقَهُمۡ وَكُفۡرِهِم بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَقَتۡلِهِمُ ٱلۡأَنۢبِيَآءَ بِغَيۡرِ حَقّٖ وَقَوۡلِهِمۡ قُلُوبُنَا غُلۡفُۢۚ بَلۡ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيۡهَا بِكُفۡرِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴾
[ النساء: 155]
﴿ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ﴾
﴿ تفسير السعدي: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ﴾
تفسير الايات 152 حتى 159 : هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على وجه العناد والاقتراح، وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم. وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل، وهذا غاية الظلم منهم والجهل، فإن الرسول بشر عبد مدبر، ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده كما قال تعالى عن الرسول، لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقا، مجرد دعوى لا دليل عليها ولا مناسبة، بل ولا شبهة، فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟ بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه، كما قال تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوه مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به. من سؤالهم له رؤية الله عيانا، واتخاذهم العجل إلهًا يعبدونه، من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم. ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة، حتى رفع الطور من فوق رءوسهم وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري. ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين، فخالفوا القول والفعل. ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة. وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير حق. ومن قولهم: إنهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه، والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه بل شُبِّه لهم غيره، فقتلوا غيره وصلبوه. وادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه، وبصدهم الناس عن سبيل الله، فصدوهم عن الحق، ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي. وبأخذهم السحت والربا مع نهي الله لهم عنه والتشديد فيه. فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمدا أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل، وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره في رد الحق أن يبين من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه، ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس، وأن له مقدمات يُجعل هذا معها. وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم به ليكتفى بذلك شرهم وينقمع باطلهم، وكل حجة سلكوها في تقريرهم لنبوة من آمنوا به فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها، دالة ومقررة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه المقابلة لم يبسطها في هذا الموضع، بل أشار إليها، وأحال على مواضعها وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل اللائق ببسطها. وقوله: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يحتمل أن الضمير هنا في قوله: قَبْلَ مَوْتِهِ يعود إلى أهل الكتاب، فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام ولكنه إيمان لا ينفع، إيمان اضطرار، فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد، وأن لا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم، فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟" ويحتمل أن الضمير في قوله: قَبْلَ مَوْتِهِ راجع إلى عيسى عليه السلام، فيكون المعنى: وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح، وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار. فإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في آخر هذه الأمة. يقتل الدجال، ويضع الجزية، ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا، يشهد عليهم بأعمالهم، وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟ وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه، مما هو مخالف لشريعة القرآن وَلِمَا دعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا بذلك، لِعِلْمِنَا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه، وأنه لا يشهد إلا بالحق، إلا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل.﴿ تفسير الوسيط: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ﴾
ثم عدد - سبحانه - ألونا أخرى من جرائمهم التى عقابهم عليها شديدا فقال - تعالى -: فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً .والفاء فى قوله فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ للتفريع على ما تقدم من قوله وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقاً غَلِيظاً والباء للسببية، وما هنا مزيدة لتأكيد نقضهم للميثاق. والجر والمجرور متعلق بمحذف لتذهب نفس السامع فى تقديره كل مذهب فى التهويل والتشنيع على هؤلاء الناقضين لعهودهم مع الله - تعالى - فيكون المعنى:فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم وبسبب كفرهم بآياتنا، وبسبب قتلهم لأنبيائنا، وبسبب أقوالهم الكاذبة. بسبب كل ذلك فعلنا بهم ما فعلنا من أنواع العقوبات الشديدة، وأنزلنا بهم ما أنزلنا من ظلم ومهانة وصغار ومسخ....الخ.ويرى بعضهم أن الجار والمجرور متعلق بقوله - تعالى - بعد ذلك حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ...أى: فبسبب نقضهم للميثاق. وكفرهم بآيات الله حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.قال الفخر الرازى: واعلم أن القول الأول أولى ويدل عليه وجهان:أحدهما: أن الكلام طويل جداً من قوله: فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ إلى قوله: فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ .الثانى: أن تلك الجنايات المذكورة بعد قوله - تعالى - فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ عظيمة جدا. لأن كفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء، وإنكارهم للتكليف بقولهم: قلوبنا غلف، أعظم الذنوب، وذكر الذنوب العظيمة، إنما يليق أن يفرع عليه العقوبة العظيمة، وتحريم بعض المأكولات عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقه بتلك الجنايات الكبيرة ".فأنت ترى أن الله - تعالى - قد لعن بنى إسرائيل كما جاء فى قوله - تعالى - فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ ومسخهم قردة وخنازير كما جاء فى قوله - تعالى فَلَماَّ عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ وكما فى قوله - تعالى - هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ وتلك العقوبات كلها إنما كانت بسبب الجنايات والمنكرات التي سجلتها عليهم الآيات القرآنية؛ والتى من أجمعها هذه الآيات التى معنا.فالآيات التى معنا تسجل عليهم نقضهم للمواثيق، ثم تسجل عليهم - ثانيا - كفرهم بآيات الله.وقد عطف - سبحانه - كفرهم بآياته على نقضهم للميثاق الذى أخذه عليهم مع أن ذلك الكفر من ثمرات النقض، للإِشعار بأن النقض فى ذاته إثم عظيم والكفر فى ذاته إثم عظيم - أيضا - من غير التفات إلى أن له سبباً أو ليس له سبب.وسجل عليهم - ثالثا - قتلهم الأنبياء بغير حق. فقد قتلوا زكريا ويحيى وغيرهما من رسل الله - تعالى -.ولا شك أن قتل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يدل على شناعة جريمة من قتلهم وعلى توغله فى الجحود والعناد والفجور إلى درجة تعجز العبارات عن وصفها، لأنه بقتله للدعاة إلى الحق، لا يريد للحق أن يظهر ولا للفضيلة أن تنتشر، ولا للخير أن يسود، وإنما يريد أن تكون الأباطيل والرذائل والشرور هى السائدة فى الأرض.وقوله: بِغَيْرِ حَقٍّ ليس قيدا؛ لأن قتل النبيين لا يكون بحق أبداً، وإنما المراد من قوله: بِغَيْرِ حَقٍّ بيان أن هؤلاء القاتلين قد بلغوا النهاية فى الظلم والفجور والتعدى.لأنهم قد قتلوا أنبياء الله بدون أى مسوغ يسوغ ذلك، وبدون أية شبهة تحملهم على ارتكاب ما ارتكبوا، وإنما فعلوا ما فعلوا لمجرد إرضاء أحقادهم وشهواتهم وأهوائهم...وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذا المعنى قوله: فإن قلت: وقتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق فما فائدة ذكره؟ قلت. معناه أنهم قتلوهم بغير حق عندهم - ولا عند غيرهم -، لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا فى الأرض فيقتلوا. وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم. فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتل.ثم سجل عليهم - رابعا - قولهم قُلُوبُنَا غُلْفٌ .وقوله: غُلْفٌ جمع أغلف - كحمر جمع أحمر - والشئ الأغلف هو الذى جعل عليه شىء يمنع وصول شئ آخر إليه.والمعنى: أن هؤلاء الجاحدين قد قالوا عندما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحق إن قلوبنا قد خلقها الله مغطاة بأغطية غليظة، وهذه الأغطية جعلتنا لا نعى شيئا مما تقوله يا محمد، ولا نفقه شيئا مما تدعونا إليه، فهم بهذا الكلام الذى حكاه القرآن عنهم، يريدون أن يتنصلوا من مسئوليتهم عن كفرهم، لأنهم يزعمون أن قلوبهم قد خلقها الله بهذه الطريقة التى حالت بينهم وبين فهم ما يراد منهم.وقريب من هذا قوله - تعالى - حكاية عن المشركين: وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيۤ أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ وقيل: إن قوله: وغلف: جمع غلاف - ككتب وكتاب - وعليه يكون المعنى: أنهم قالوا إن قلوبنا غلف أى أوعية للعلم شأنها فى ذلك شأن الكتب، فلا حاجة بنا يا محمد إلى ما تدعونا إليه، لأننا عندنا ما يكفينا.والذى يبدو لنا أن التأويل الأول أولى، لأنه أقرب إلى سياق الآية، فقد رد الله عليهم بقوله: بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً . والطبع معناه. إحكام الغلق على الشئ وختمه بحيث لا ينفذ إليه شئ آخر.والمعنى: أن هؤلاء القائلين إن قلوبهم غلف كاذبون فيما يقولون، وتخليهم عن مسئولية الكفر ليس صحيحا. لأن كفرهم ليس سببه أن قلوبهم قد خلقت مغطاة بأغطية تحجب عنها إدراك الحق - كما يزعمون - بل الحق أن الله - تعالى - ختم عليها، وطمس معالم الحق فيها، بسبب كفرهم وأعمالهم القبيحة. فهو - سبحانه - قد خلق القلوب على الفطرة، بحيث تتمكن من اختيار الخير والشر، إلا أن هؤلاء اليهود قد أعرضوا عن الخير إلى الشر، واختاروا الكفر على الإِيمان نتيجة انقيادهم لأهوائهم وشهواتهم. فالله - تعالى - طبع على قلوبهم بسبب إيثارهم سبيل الغى على سبيل الرشد، فصاروا لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا قيمة له عند الله - تعالى -.فقوله إِلاَّ قَلِيلاً نعت لمصدر محذوف أى إلا إيماناً قليلا. كإيمانهم بنبوة موسى - عليه السلام - وإنما كان إيمانهم هذا لا قيمة له عند الله، لأن الإِيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعضهم، يعتبره الإِسلام كفرا بالكل كما سبق أن بينا فى قوله - تعالى - إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقّاً ومنهم من جعل قوله إِلاَّ قَلِيلاً صفة لزمان محذوف أى: فلا يؤمنون إلا زمانا قليلا. ومنهم من جعل الاستثناء فى قوله إِلاَّ قَلِيلاً من جماعة اليهود المدلول عليهم بالواو فى قوله فَلاَ يُؤْمِنُونَ أى: فلا يؤمنون إلا عددا قليلا منهم كعبد الله بن سلام وأشباهه. والجملة الكريمة وهى قوله: طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ معترضة بين الجمل المتعاطفة. وقد جئ بها للمسارعة إلى رد مزاعمهم الفاسدة، وأقاربهم الباطلة.﴿ تفسير البغوي: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ﴾
قوله تعالى : ( فبما نقضهم ميثاقهم ) أي : فبنقضهم ، و " ما " صلة كقوله تعالى : " فبما رحمة من الله " ( آل عمران - 159 ) ، ونحوها ، ( وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم ) أي : ختم عليها ، ( فلا يؤمنون إلا قليلا ) يعني : ممن كذب الرسل لا ممن طبع على قلبه ، لأن من طبع الله على قلبه لا يؤمن أبدا ، وأراد بالقليل : عبد الله بن سلام وأصحابه ، وقيل : معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا .
المصدر : فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا